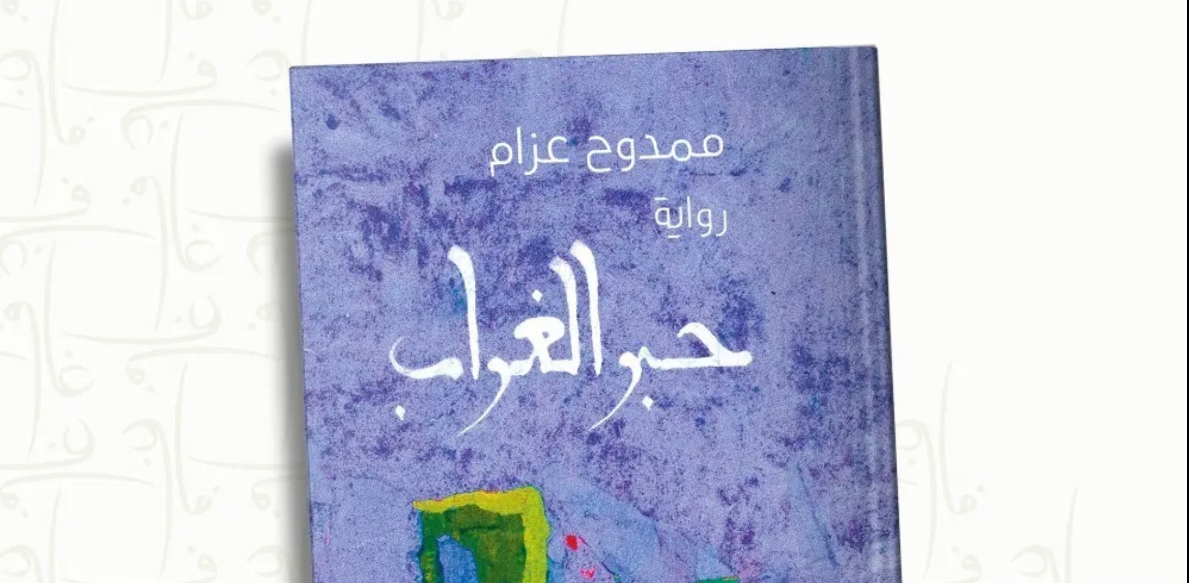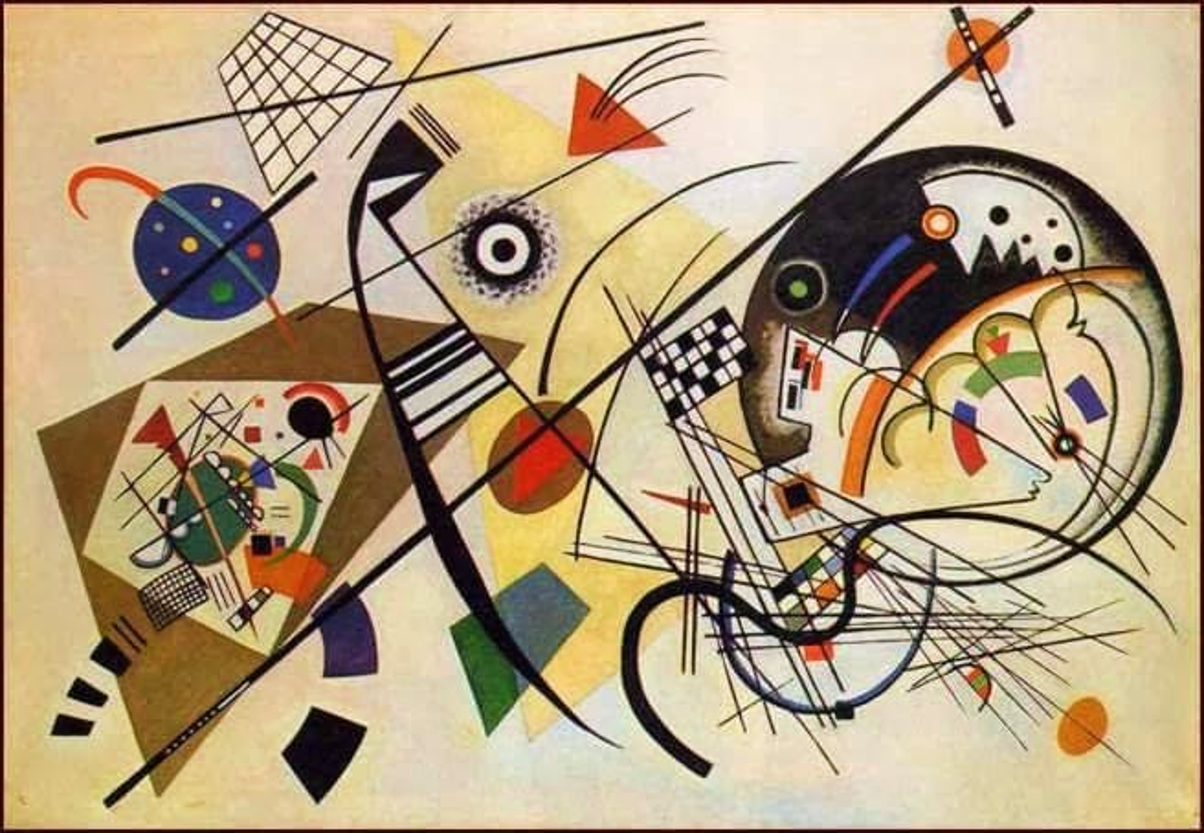تدور رواية ”حبر الغراب“ للروائي ممدوح عزام حول قطبين أساسيين: الأول، مكتبة شيدها عددٌ من أهالي بلدة تُدعى السماقيات في السويداء، وحين وصلت سلطة جديدة إلى الحكم (سلطة البعث بحسب زمن الرواية)، تعرّضت المكتبة للتدمير والنهب. أما القطب الثاني فهو شخصية أمين المكتبة، الذي قُتل داخلها في الهجوم نفسه، وسجلت السلطات الجريمة على أنها انتحار. تمثل المكتبة المحور الرئيس للسرد، بينما الأمين المقتول، رغم أهميته الرمزية كراعٍ للوعي، إلا أن حدث الموت، موته هو، حدث ذكرى وأثر فردي لدى أبناء البلدة، في المقابل، يُعدّ دمار المكتبة حدثاً جماعياً يمسّ الوعي الجمعي، لأن المكتبة في الرواية هي المصدر الأساس للمعنى بالنسبة للشخصيات، وككل معنى، فإن وجوده يمنح الحياة للأفراد وزواله يعرضهم للتشظي والتيه. تتبع الرواية محاولات أحد أبناء البلدة فهم ماجرى ليلة الهجوم وكشف المجرمين. هذا الشخص هو السارد في الرواية، ومع ذلك فالرواية ليست عنه. كما أن الرواية ليست خطية بأي شكل، فهي سلسلة من المشاهد التفاعلية المتزامنة، تتناوب الشخصيات على سرد قصصها. هذه الشخصيات لا تتقاطع بالضرورة، مع أن معظمها من البلدة نفسها ولهم الصلة نفسها مع المكتبة، إلا أن الروابط المباشرة بينها قليلة. ما يجمعها حقاً هو المصير المشترك والمكتبة، وهما العنصران اللذان يمنحان القارئ إحساساً بوحدة الحياة في الرواية.
تدمير ونهب المكتبة:
المكتبة في الرواية هي الدالّ الرئيس الذي تتمحور حوله مجموعة الشخصيات في الرواية. ومن هذا الدال، تقوم الشخصيات المختلفة بتشكيل دوالّها الخاصة، أي حياتها المتفردة التي تشكل أجزاء من الكل. وبذلك، تصبح ذواتاً ضمن البنية التي توفرها هذه الدالة الأولية. فالمكتبة تسمح للشخصيات بالنضج والتفتح بسبب تعاملها مع الكتب وتواصلها مع بعضها، رغم كل التناقضات فيما بينها. فمنذ البداية، نجد صديقين: الأول ماركسي يسعى إلى التأثير والتغيير المباشر والآخر أكثر هيغلية – وهو أمين المكتبة – إذ يرى أن التغيير يبدأ من الوعي. الأول اعتُقل ثم أُفرج عنه لاحقاً، أما الثاني فقد قتلته السلطة، تعاملت معه بوحشية أكبر وقضت عليه، توحي الرواية بأن السلطة تحدّ الفعل وتقضي على الوعي لأنها تجده أكثر خطراً عليها. ومع تدمير المكتبة، فقدت الشخصيات الدال الرئيس في حياتها. في الحقيقة لا يمكن وصفه بمجرد فقد، لأن الفقد لا يعني استحالة تحول الفرد إلى ذات، إذ تستطيع الأنا التعامل مع هذا الفقد وتوليدالمعنى منه، وإن كان على نحو مختلف عما كان في حضوره. لكن ما حدث في ”حبر الغراب“ أن الدالّ الرئيس (المكتبة) جرى تدميره ونهبه بالكامل على يد سلطة طغيانية وأصبحت كما لو أنه لم يوجد يوماً، فلا السلطة تعترف بوجوده السابق ولا هي تسمح للأفراد بذكره. وهكذا على الشخصيات التعامل مع التدمير والفقد وإنكار حدوث الأمرين، والمعادلة أقرب إلى الاستحالة. جلب هذا التدمير سلسلة من الكوارث على البلدة، فقر وانعدام فرص العمل، وتمزّق حياة الشخصيات وتناثر بعضها بعيداً عن المكان: بلدة السماقيات. لكن هذا لم يعن، بالنسبة لعزام، الصمت أو العدمية أو الاستسلام لسلطة الطغيان، السلطة التي لا تسمح للأفراد بالوجود ضمن بنية جماعية للبلدة، ولا الوجود المتفرد، فهذه السلطة تريدهم أدوات أمنية وعسكرية تكرّس وجودها وتحولهم إلى وشاة وأمنيين. هذا النوع من ”التذويتّ“ هو الذي تسعى السلطة لإنتاجه وتعزيزه. ويقف عزام على النقيض من الرضوخ ومن الصمت والعدمية حيث يقدم في الرواية مشروعاً لإعادة بناء دال رئيس جديد. صحيح أنه ليس محدداً متماسكاً وثابتاً كما كانت المكتبة، لكنه ليس مُدمراً وغائباً أيضاً. هو دالّ متوزّع ومخفي بين مجموعة أفراد البلدة وهو: كتب المكتبة الموزعة بين الشخصيات، والأثر المتروك على هوامش الكتب من قبلهم. والأثر، بالضرورة، موجود وخفي؛ إذ لا يعلن عن نفسه، أي عن كاتبه، إلا أمام الآخر الذي يعرفه. وعلى هذا النحو تحوّلت المكتبة إلى مجموعة أجزاء، يصعب على السلطة تحديدها. ويقوم سارد الرواية بجمع خيوط الأجزاء من خلال تقفي كتب المكتبة المختومة ببصمة خاصة: ”السماقيات“. ختمٌ خاص، غير مملوك، وضعه أبناء البلدة على الكتب لجعلها متفرّدة. وهكذا فإن الدال الجديد مكّون من كتبٍ موزعة، يحمل كل واحد أثار تشرح معناه الخاص لشخصيات الرواية. ويضيف عزام إلى هذا وذاك بعداً آخر هو الحكايات في سياق يقترحه أن يكون: الحب. لأن المعرفة كما يقدمها تأتي مع الحب. ومن هنا، أصبح تتبع أثر الكتب مصحوباً بسلسلة من قصص الحب.
الكتب المتناثرة + حكاية الشخصيات + الحب <==> الدال الأولي الجديد
إذن، يريد عزام من شخوصه أن تتحدث، أن تسرد قصصها، لأن سرد الحكايات حول الكتب والحب والفشل في الحب يمكّن الأفراد من تشكيل الدال الرئيس، الذي يجمع شخوص البلدة ويجعلهم فاعلين. فالهدف من القصص ومن التواصل عبر الكتب والحب هو تمكين الشخصيات من المقاومة وبناء ذواتها بعيداً عن طغيان السلطة. لا يهم إن كانت هذه القصص خيالية كما في القصة الأولى حيث البطل فيها قارئ واسع الاطلاع ومعرفته جعلته يعيش حياتين: واحدة في الخيال وأخرى مادية جداً. أما القصة الثانية، التي وجدتها نوفيلا في ذاتها، رغم أنها أكثر القصص تجسيداً لفكرة الرواية، فبطلها يتزوج من فتاة أحبها، لكنها تصده منذ الليلة الأولى لزواجهما. ,يكتشف لاحقاً حبها لشاب سبقه، علم بالأمر من أثر رسائلها المكتوبة على هوامش كتاب كان يمرر بينهما. حين علم الزوج، تغيّر حاله تماماً، لأن ذكورته (داله الشخصي) تعرضت للإذلال. استسلم للغيرة بعدما أدرك، من خلال الأثر، أنها لم تحبه يوماً كما أحبت الآخر. ومنافسة الأثر، هذه المنافسة المستحيلة، زادته شغفاً بها وغضباً منها، صار يراقبها ليؤكد خيانتها له، وعندما لا يكتشف أي شيء، يتضاءل غضبه ويتجاوز شفقته على ذاته إلى الفعل: بدأ بالكتابة لها على طريقة الحب السابق، عبارات حب مقتبسة من الكتاب نفسه، ثم تطوّر الأمر إلى كتابة كلمات خاصة به. هذه الكتابة مكنته من استعادة ذاته ودالّه الشخصي. حصل هذا دون أن يعرف أن زوجته لا تقرأ أياً من رسائله، بل كانت ترميها فور تسلمها، من دون أن تعرف المرسل. أما القصة الثالثة فكانت الأقسى من حيث تدمير الدال، إذ تقوم السلطة بإخصاء البطل، ما يدفعه إلى الانطواء على نفسه والابتعاد عن زوجته، منصرفاً إلى قراءة رواية لنجيب محفوظ تتحدث عن بطل مخصي، لكن البطل بقصة عزام ينتحر، وتحاول زوجته بعد موته أن تفهم سبب ابتعاده عنها، لتكتشف عن السر في رواية محفوظ. وهكذا، تتوالى القصص في تناقض يجمع بين الانقباض والانبساط داخل البيئة التي فرضتها سلطة القمع.
قصص عن الحب، شخصيات تمزقت حياتها، وأخرى تبحث عن الحقيقة والعدالة.
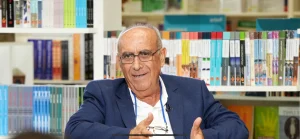
لا يقدّم ممدوح عزام في روايته الحلّ كما لو أنّ تتبّع خطواته في تقفّي الكتب وسرد الحكايات والحب يفضي حتماً إلى النجاة. فربما تفشل الطريقة ويفشل الأدب، ويبقى “حبر الغراب” يخط سطوراً عن الشؤم الذي ينتظر البلاد. تنتهي الرواية بلا نجاة وبلا انتهاء، نهايةٌ تقدّم الحقيقة دون أن تنهي المأساة، كما لو أنّ الكاتب كان يعرف أن التاريخ يعيد نفسه، دائماً على هيئة مأساة. فالكارثة التي صاغها خيالاً بقيت ماثلة كاحتمال، وظلّت ممكنة الحدوث. وهذا ما حدث بالفعل، فقد أقدمت السلطة الجديدة في دمشق على تدمير مكتبة الروائي ممدوح عزام ومن ثم حرقها. مكتبته في السويداء أحرقت. والنار، كما يرد في الرواية، أكثر من القبور، شغوفة بالتخلّص: ” النار تعادل الإبادة والمحو“. لقد أُبيدت مكتبة عزام، لكننا سنواجه الإبادة على طريقته في حبر الغراب: بقراءة كتب عزام التي تحمل أثر مكتبته، نُحيي المكتبة التي أُحرقت، أُبيدت. وعن طريق سرد حكاياتنا مع الكتب، نعيد للكتب التي أبيدت الحياة. وبعيشنا الحبّ نعيد إلى الوجود مكتبة ممدوح عزام. المكتبة التي أُبيدت واقعاً، وبقيت فينا، ما دمنا نقرأ ونسرد ونحب.