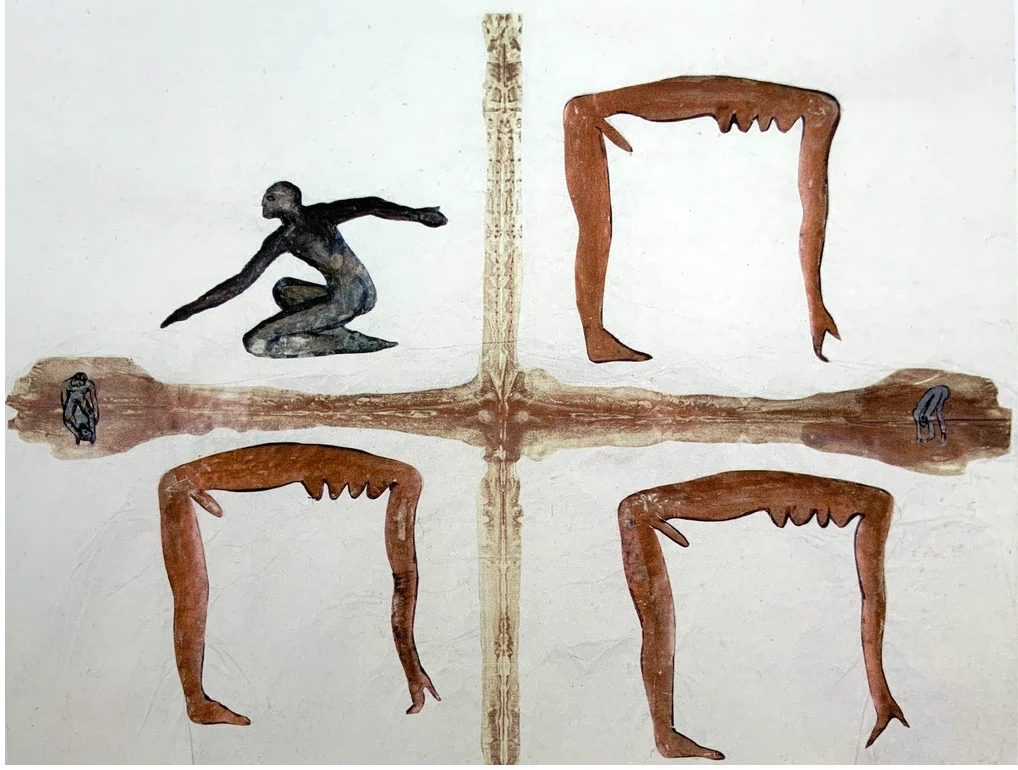مددت من النافذة رأسي فقط. فعلت ذلك بهدوء حتى لا أزعج نوم الآخرين الذين يسكنون في الغرف المجاورة. من النافذة، أمتلك إطلالة رائعة على ضواحي حلب، خارج لندن. كنت ألاحق المخدة التي تهرب مني في كل مرة أحاول فيها النوم. لا أدري، دائما هكذا تسير الأمور معي. أشياء تهرب، وأخرى تسبقني، وفي مرات كثيرة أضيع أنا من نفسي. أتذكر الوقت الذي عملت فيه مهندساً، عُينت في قسم البرمجة، كانت واحدة من تلك المراحل التي كنت أشعر فيها أنني شديد الغباء، فكل مرة كنت أجد فيها حلاً لمشكلة تقنية، أقرب يدي من لوحة المفاتيح وقبل ضغط أي حرف، يظهر الكود الذي كنت أنوي كتابته من تلقاء نفسه، سباق هُزمت فيه دوماً. حاولت إخفاء الأمر والاكتفاء بمرارة الإخفاق. في البداية، نجحت ومع الأيام أصبحت مبهوراً بتلك العبقرية المنتشرة في كل مكان. أحياناً، كنت أرغب في إضافة شيء، دون جدوى، حاولت. بعدها أصبحت أشرد عن الشاشة مطولاً، أفكر بأبي الذي يخرج من البيت مبكراً وبيده جهاز كشف عن المعادن، يمررها على أجساد الشجر بعد أن اكتشف عدداً كبيراً من الشظايا ورصاصات الرشاش فيها. راح يسجل عدد الأشجار المصابة، تحت قائمة ”نجت من الحرب“ ويحدد موقع كل واحدة، ليطمئن عليها لاحقاً. تحوّل أبي إلى كائن مهووس بالشجر بعد أن بحث طويلاً عن أصحابه وأولاده، وفشل في معرفة مصيرهم. تركت الحاسب يعمل وحده، وتفرغت لكتابة رسائل إلى أبي أحاول فيها إقناعه بفكرة أن الموت ليس أسوء ما يمكن حدوثه للمرء، في كثير من الأحيان قد تكون بداية جديدة، رفض ذلك بشكلٍ قاطع، حتى وصل به الأمر أنه طلب عدم استخدام كلمة ”الموت“ في رسائلنا كما لو أنه أمرٌ إذا توقف الناس عن ذكره، فلن يحدث. حذفت الكلمة من رسائلي واستبدلتها بخمس نقاط. لم يتوقف الأمر هنا فقد طلب بعد مدة التوقف عن كتابة كلمات أخرى مثل المرض والفقد والعناء…. تحولت رسائلي إلى نقاط مطولة تتخللها كلمة هنا وهناك. ظنّ المدير -الذي انحنى ليرى شاشتي بعد أن سبقه بفعل الأمر نفسه جميع زملائي، دون أن انتبه – أنها تسريبات مشفرة عن عملنا إلى شركة منافسة، فطردني.
أرى من نافذتي، عدداً من المخدات المتطايرة وأيادي ممدودة لالتقاطها، وكذلك أرى ظل سيدةٍ تتحرك بقلقٍ خلف نوافذها التي تغلقها بشكلٍ محكم كل يوم ابتداءً من الغسق، تقول:”ليس من ذلك بدّ“. وهناك أيضاً عدد من الرجال ممن هرب منهم قلبهم، وآخرين نصف جسدهم السفلي بات خارج النافذة بقليل. ينتظرون جميعهم ظهور السيدة التي تسكن في الطابق الأعلى فوق شقتي. أحببتها أنا أيضاً رغم أني لم أرها يوماً، اتساءل إن كانوا جميعهم شاهدوها يوماً؟ أم أن الحالة هي حب عن حب عن حب. في الساحة التي تفصل النوافذ عن بعضها، أوقف رجلا شرطة أحد الجيران، أطلقت عليه اسم مولوي بطل بيكيت -لأني أرى بيكيت حيث لا وجود له – كان يعاني من آلام في القدم ويمتلك دراجة أيضاً، ومثله يضطر إلى إراحة قدمه كل حين، فيستلقي على ظهره في الساحة، مبعداً بين قدميه ويمسك قضيبه موجهاً إياه إلى النوافذ في الأعلى. سألته الشرطة عن سبب وجوده على هذه الحال وفي هذا الوقت؟ مولوي هذا يختلف عن بطل بيكيت بأنه يفضل أن يراه الناس شريراً على أن يروه قليل خبرة ومعطوب، فيبدأ بالكلام عن نفسه، بصوتٍ مسموع للجميع دون توقف. أرغب في التعاطف معه كما فعلت مع بطل بيكيت، لكن هذا أراه متحذلقاً، خالياً من روح الفكاهة، مركزاً الاهتمام على نفسه، في بعض الأحيان يكاد ينجح في أن يكون وغداً. وقد يكون السبب الحقيقي أبسط مما أفترض وهو أن المرء يتعاطف مع الشخصيات في الكتب، بصورةٍ أسهل مما يحدث في الواقع، حيث التوجس هو الحاضر غالباً.
في اللحظة التي ظهرت السيدة في الأعلى أمام النافذة، استغل مولوي انشغال الجميع بها. قفز بساقه العرجاء على دراجته، قفزة سريعة الزوال، واختفى. تراجعت حينها عن حافة النافذة إلى طاولة الحاسب، أردت أن أكتب ما فكرت به وما حدث، عن أبي ومولوي وحلب التي أراها من بعيد، لكنني وجدت كل هذا منشوراً هنا مسبقاً.